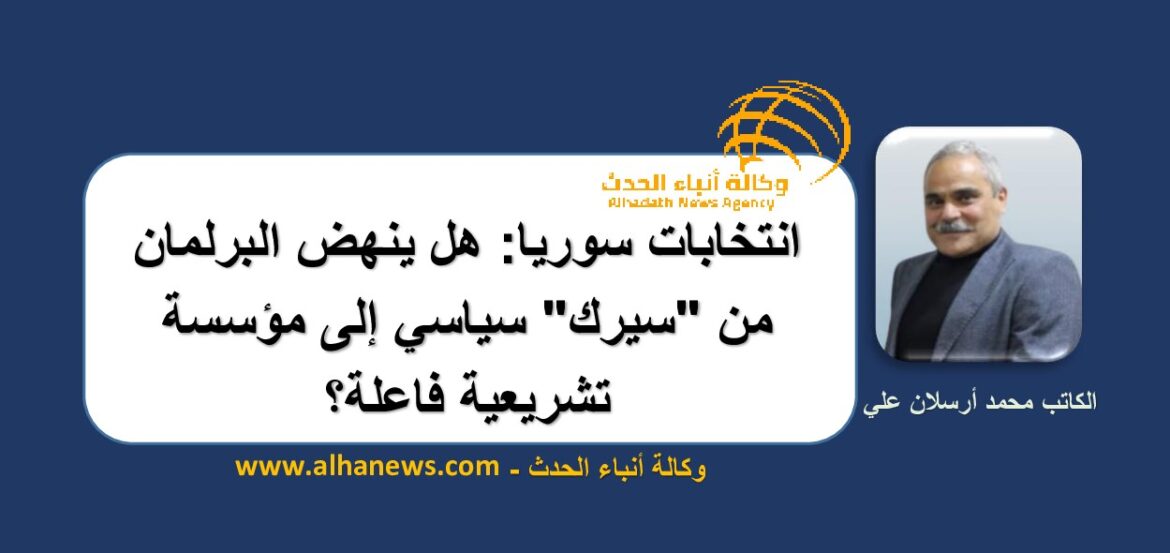الكاتب والمفكر محمد أرسلان يكتب : انتخابات سوريا: هل ينهض البرلمان من “سيرك” سياسي إلى مؤسسة تشريعية فاعلة؟
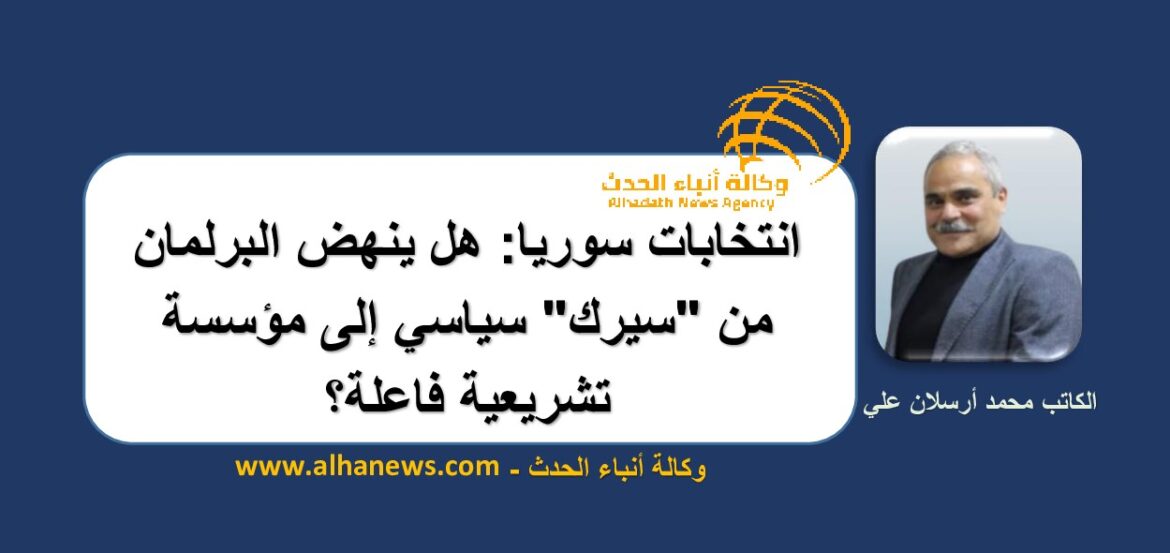
الحدث – بغداد
يشهد المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا، ظاهرة مثيرة للقلق تتمثل في انحسار دور المؤسسات التشريعية وتحولها من منبر للسيادة الشعبية ومحاسبة الحكومة إلى ما يشبه “سيرك” سياسي. هذه الحالة من التدهور دفعت البعض إلى الاعتقاد الخاطئ بأنها ناتجة عن “ديمقراطية زائدة” أفرزت الفوضى والمشاحنات اللفظية والجسدية بين النواب. إلا أن هذا التوصيف لا يلامس جوهر المشكلة، بل هو مجرد عرض من أعراضها. إن الفوضى والمشادات العلنية التي تُظهرها هذه المؤسسات ليست نتاجاً لـ”فرط” الديمقراطية، بل هي دليل على غيابها الحقيقي.
تاريخياً، وُجدت البرلمانات لتكون سلطة مستقلة وفاعلة توازن السلطة التنفيذية. عندما تُفرغ هذه المؤسسة من صلاحياتها الجوهرية وتصبح مجرد واجهة، يفقد أعضاؤها المحفز الحقيقي للعمل السياسي الرصين (كالتشريع والرقابة)، مما يدفعهم إلى استخدامها كمنصة للشد والجذب بعيداً عن جوهر العمل المؤسسي. هيمنة السلطة التنفيذية على العملية التشريعية، كما يحدث في أنظمة كثيرة، تحوّل البرلمان إلى سلطة تابعة، حيث تصبح المراسيم والقوانين الصادرة عن الحكومة أقوى من القوانين البرلمانية.
حيث تستمد البرلمانات أهميتها من أدوارها الجوهرية في أي نظام ديمقراطي، وهي الأدوار التي تضمن التوازن بين السلطات. يمكن تلخيص هذه الأدوار في ثلاثة وظائف رئيسية: التشريع، الرقابة، والتمثيل. فالوظيفة التشريعية، تتمثل في سن التشريعات والقوانين اللازمة للدولة واقتراحها ومناقشتها. في الأنظمة الديمقراطية، يُفترض أن يتقاسم البرلمان هذا الدور مع السلطة التنفيذية، إلا أن الدور التشريعي للبرلمانات يتناقص بشكل ملحوظ في العديد من الأنظمة لصالح السلطة التنفيذية. أما الوظيفة الرقابية والتي هي جوهر مبدأ فصل السلطات، وتتمثل في مساءلة الحكومة ومراقبة أعمالها. تمنح الدساتير للبرلمانات أدوات رقابية فعّالة، مثل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات المناقشة العامة، لمراقبة أداء الحكومة والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات. بينما الوظيفة التمثيلية والتييكون فيها البرلمان منصة لتمثيل كامل أطياف المجتمع، بما في ذلك الغالبيات والأقليات. يتطلع البرلمانيون إلى العمل معاً لإيجاد حلول تستجيب لاحتياجات ومخاوف دوائرهم الانتخابية. كما أنهم يُعدّون الصوت الذي يرفع مطالب المواطنين إلى الحكومة، ويسعون لتحويل هذه المطالب إلى سياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كان ذلك من الناحية النظرية، أما على أرض الواقع حيث أدت مجموعة من العوامل المتشابكة إلى تراجع دور البرلمانات، وتحويلها من سلطة فاعلة إلى مؤسسة تابعة. حيث هيمنة السلطة التنفيذية على العملية التشريعية واضحة بشكل فاقع. وشهد العصر الحديث تعقيداً متزايداً في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أدى هذا التعقيد، بالإضافة إلى الأزمات الكبرى مثل الحروب، إلى منح السلطة التنفيذية اليد العليا في عملية صنع القرار. تمتلك الحكومات الأجهزة المتخصصة والخبرات الفنية اللازمة لاتخاذ قرارات سريعة وفعّالة، وهو ما يفتقر إليه البرلمان بشكل عام، مما يجعله عاجزاً عن مواجهة الأزمات. هذه السيطرة امتدت لتشمل المجال التشريعي، حيث أصبحت السلطة التنفيذية هي من يضع مشاريع القوانين ويشارك في الدفاع عنها، بل وتصدر مراسيم وقوانين خاصة بها، مما قلّص من الدور التشريعي للبرلمان وأدى إلى تدهوره.
فقدان الثقة الشعبية حيث ينشأ الضعف المؤسسي للبرلمان عن حلقة مفرغة من انعدام الثقة. عندما يصبح البرلمان غير قادر على معالجة المشكلات الحقيقية للمواطنين، يفقد شرعيته في أعينهم. هذا الانفصال بين المؤسسة التشريعية والشارع يجعلها عرضة للنقد اللاذع، حيث يسهل انتقاد النواب والأحزاب مقارنة بانتقاد أطراف أخرى مثل الحكومات. يؤدي فقدان الثقة إلى إضعاف البرلمان سياسياً، مما يجعله أقل قدرة على مواجهة هيمنة السلطة التنفيذية، وهذا يغذي الشعور الشعبي بأن البرلمان مجرد “سيرك” سياسي، بينما هو في الواقع ضحية لآليات هيكلية أفرغته من محتواه.
لم يكن البرلمان السوري بمنأى عن التحولات التي طرأت على دور المؤسسة التشريعية، إلا أن مساره تميز بتحول جذري من مؤسسة فاعلة إلى هيئة شكلية. حيث كان البرلمان السوري في فترة من الفترات يعيش العصر الذهبي وكان ذلك في (قبل 1963). حيث تُظهر السجلات التاريخية أن البرلمان السوري كان، قبل عام 1963، أقوى مؤسسة سياسية في البلاد. فقد كان الدستور يمنح البرلمان صلاحيات حقيقية، كمساءلة الحكومة وتصديق المعاهدات، بل إن جميع رؤساء الدولة ورؤساء الوزراء الذين لم تكن لهم خلفية عسكرية كانوا من خلفية برلمانية. شهدت هذه الفترة، التي تأسس فيها مجلس النواب عام 1930، صراعات سياسية بين النواب والمفوض الفرنسي على مبدأ “سيادة الأمة”، مما أدى إلى حل المجلس في بعض الأحيان. كان هذا البرلمان يمارس صلاحياته بشكل فعال، حيث كان يمكنه سحب الثقة من الحكومة، مما يؤكد دوره الحقيقي في تشكيل المشهد السياسي.
ولكن بعد 1963 وحتى 2024 تحول نحو الهيمنة. حيث شكل الانقلاب الذي قام به حزب البعث في 8 آذار/مارس 1963 نقطة تحول حاسمة. فقد أدى الانقلاب إلى حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، لتبدأ مرحلة جديدة من الهيمنة العسكرية والسياسية على المؤسسة التشريعية. منذ عام 1971، تحوّل مجلس الشعب إلى هيئة تشريعية شكلية تابعة للسلطة التنفيذية، حيث يتقاسم رئيس الجمهورية السلطة التشريعية معه من خلال إصدار المراسيم التشريعية. كان هيكل المجلس في هذه الحقبة مصمماً لضمان السيطرة الكاملة للنظام. كان يتألف من 250 نائباً، يتم توزيع مقاعدهم بشكل مسبق لضمان أغلبية ساحقة لحزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. كانت مقاعد العمال والفلاحين تمثل 51% من الإجمالي، بينما كانت أحزاب الجبهة تحصل على 25%، وكانت بقية المقاعد تُخصص للمستقلين. هذا الهيكل لم يكن نتاج “ديمقراطية” كما يصفها البعض، بل هو هندسة سياسية دقيقة لضمان الولاء للسلطة، وليس التمثيل الحقيقي للشعب. وعليه، أصبح دور النواب مجرّد واجهة لا تتجاوز حدود إظهار “وحدة المجتمع والتفافه حول السلطة التنفيذية”.
بينما الانتخابات المزمع إجراءها خلال الأيام المقبلة 15 – 20 أيلول 2025 في ظل السلطة المؤقتة، والتي أقرت بأن ثلث أعضاء البرلمان سيتم تعيينهم من قبل الجولاني رئيس السلطة المؤقتة، بينما الثلثين الآخرين سيتم انتخابهم من قبل لجنة تم تعيينها من الجولاني ذاته. حيث بعد هروب النظام السابق، أعلنت الإدارة الانتقالية عن حل مجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور عام 2012، في خطوة وصفت بأنها بداية لمرحلة جديدة. إلا أن النظام الانتخابي المؤقت الذي أقرته الإدارة الانتقالية بموجب المرسوم رقم 142 لعام 2025 يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة البرلمان الجديد. حيث حسب النظام الانتخابي المؤقت (مرسوم 142)، سيتألف المجلس الجديد من 210 أعضاء. يتم انتخاب ثلثي الأعضاء (140) بينما يتم تعيين الثلث المتبقي (70) مباشرة من قبل الرئيس. هذه المقاعد المخصصة بالتعيين تهدف إلى “سد الثغرات التي قد تنشأ عن العملية الانتخابية وضمان التمثيل المتنوع”. وحتى آلية الانتخابات تم التلاعب بها، لتكون النتائج حسب أهوائهم. حيث سيحل نظام الانتخابات غير المباشرة محل الانتخابات المباشرة التي كانت متبعة سابقاً. فبدلاً من تصويت الشعب، سيتم تشكيل “هيئات انتخابية محلية” في كل محافظة، والتي ستقوم بدورها باختيار أعضاء المجلس. تبرر اللجنة العليا هذا النهج بنقص البنية التحتية اللازمة لإجراء انتخابات مباشرة.
مع هذا النظام الانتخابي المؤقت والذي يحمل في طياته مخاطر كبيرة يمكن أن تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس مشكلات البرلمان السابق. التخلي عن التمثيل الشعبي المباشر يضعف الشرعية الديمقراطية للمؤسسة التشريعية قبل أن تتشكل. كما أن منح الرئيس سلطة مطلقة في تعيين ثلث الأعضاء قد يؤدي إلى إنشاء برلمان موالٍ للسلطة التنفيذية، على غرار ما كان عليه الحال في عهد النظام السابق.
وللخروج من مأزق “البرلمان-السيرك” يتطلب أكثر من مجرد تغيير الوجوه. يحتاج الأمر إلى خارطة طريق شاملة تستهدف الإصلاح المؤسسي والجذري.
حيث تُعد اللامركزية حلاً جذرياً لمشكلة التنوع السياسي والإثني والديني في سوريا، وهي ليست مرادفاً للتقسيم، بل هي آلية لتعزيز الوحدة من خلال الاعتراف بالتنوع. ومنذ أكثر من عقد ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية تطرح مشروع اللامركزية في سوريا، من خلال الاتفاقيات التي تمت في الفترة الأخيرة أو من خلال كافة البيانات الرسمية. وحتى أن الهيئة التشريعية في شمال وشرق سوريا يمكن أن تكون انموذجاً للبرلمان في سوريا وبرلمانات الأقاليم. ومن المهم التمييز بين نوعين من اللامركزية:
اللامركزية الإدارية: وهي توزيع الوظائف والمهام الإدارية بين الجهاز المركزي والهيئات المحلية.
اللامركزية السياسية: وهي توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية بين الحكومة المركزية وحكومات وبرلمانات محلية، مما يمنح المواطنين أو ممثليهم المنتخبين سلطة أكبر في صنع القرار.
توفر اللامركزية السياسية حلاً عملياً للصراع المحتمل، حيث تمنح الأقليات “نوعاً من الإدارة الذاتية دون المساس بالوحدة السياسية للدولة”. كما أنها تعزز المشاركة الشعبية على المستوى المحلي وتقلل من مخاطر القرارات الخاطئة، حيث يكون ضررها محصوراً في نطاق جغرافي محدود.
ويتطلب إصلاح البرلمان السوري جهداً متعدد الأوجه يستهدف الهيكل القانوني والإداري للمؤسسة. حيث ينبغي البدء بوضع دستور دائم يكرّس مبدأ فصل السلطات ويضمن استقلالية المؤسسة التشريعية عن السلطة التنفيذية. يجب أن يمنح الدستور البرلمان صلاحيات كاملة في التشريع والرقابة، ويعزز أدواته الرقابية مثل لجان التحقيق. ويجب الاستثمار في بناء قدرات النواب من خلال التدريب المستمر في مجالات التشريع والرقابة. كما يجب تحديث البنية التحتية للمجلس وتوفير مراكز بحوث ومكتبات برلمانية متطورة، مما يعزز قدرة النواب على اتخاذ قرارات مدروسة.
وبكل تأكيد لا يمكن للإصلاح أن يتحقق بمعزل عن المجتمع. يجب إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومراكز الأبحاث في عملية الإصلاح، فمسؤولية تطوير البرلمان هي مسؤولية جماعية تهدف إلى تحقيق الحكم الرشيد.
إن تحول البرلمانات إلى ساحات فوضى ليست نتيجة “ديمقراطية زائدة” كما يُشاع، بل هي نتاج ضعف مؤسسي وهيكلي أفرغها من محتواها. إن أزمة البرلمان السوري هي في جوهرها أزمة ثقة، لا يمكن حلها إلا من خلال إصلاح شامل يهدف إلى استعادة دوره كممثل حقيقي للشعب. يكمن الحل في الانتقال من نظام مركزي يفرض الوصاية إلى نظام لا مركزي يعترف بالتنوع. إن الطريق نحو سوريا تعددية لا مركزية ديمقراطية يتطلب بالدرجة الأولى وضع دستور دائم يضمن استقلالية المؤسسة التشريعية ويكرس مبدأ فصل السلطات. وكذلك اعتماد نظام انتخابي مباشر وشفاف يضمن التمثيل الحقيقي للشعب. والأمر الثالث الهام هو تطبيق لامركزية سياسية حقيقية تمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في التشريع والإدارة، مما يقلل من احتمالات الصراع ويؤسس لوحدة مبنية على التنوع. وأخيراً الاستثمار في بناء قدرات النواب فنياً وإدارياً، وتحديث البنية التحتية للبرلمان. وذلك سيكون من خلال تسهيل مشاركة المجتمع المدني والأحزاب في العملية السياسية، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء دولة القانون.
إن الإصلاح البرلماني في سوريا هو مفتاح بناء دولة مدنية تعددية، والحل لا يكمن في إلغاء المؤسسة أو تهميشها، بل في إعادة تفعيلها ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من أن تكون صوتاً للشعب، ومحركاً للتغيير والإصلاح.
 +00000000
+00000000