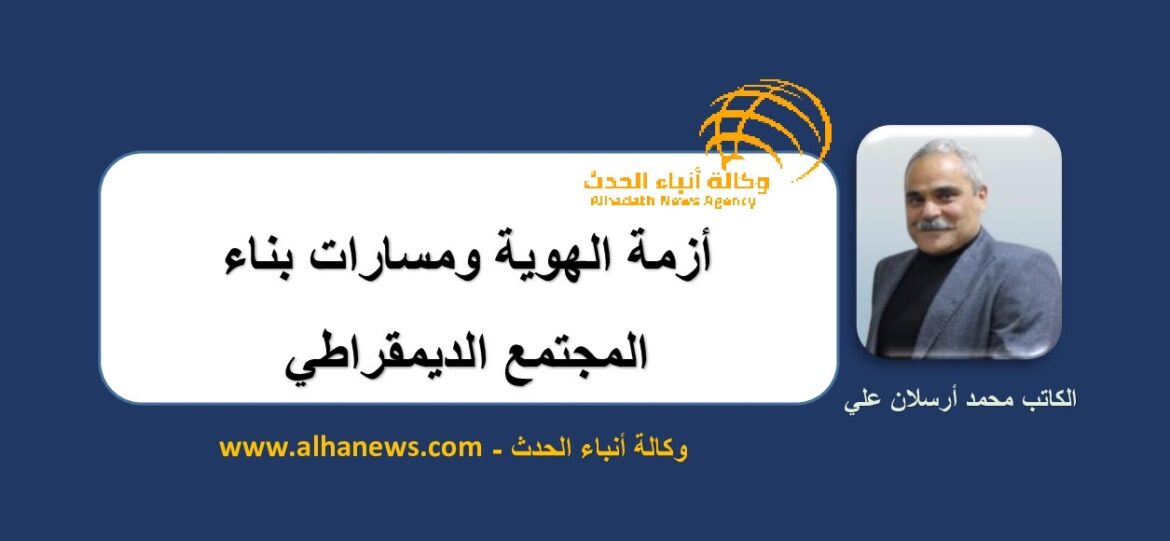المفكر الكردي الكبير محمد أرسلان يكتب : أزمة الهوية ومسارات بناء المجتمع الديمقراطي
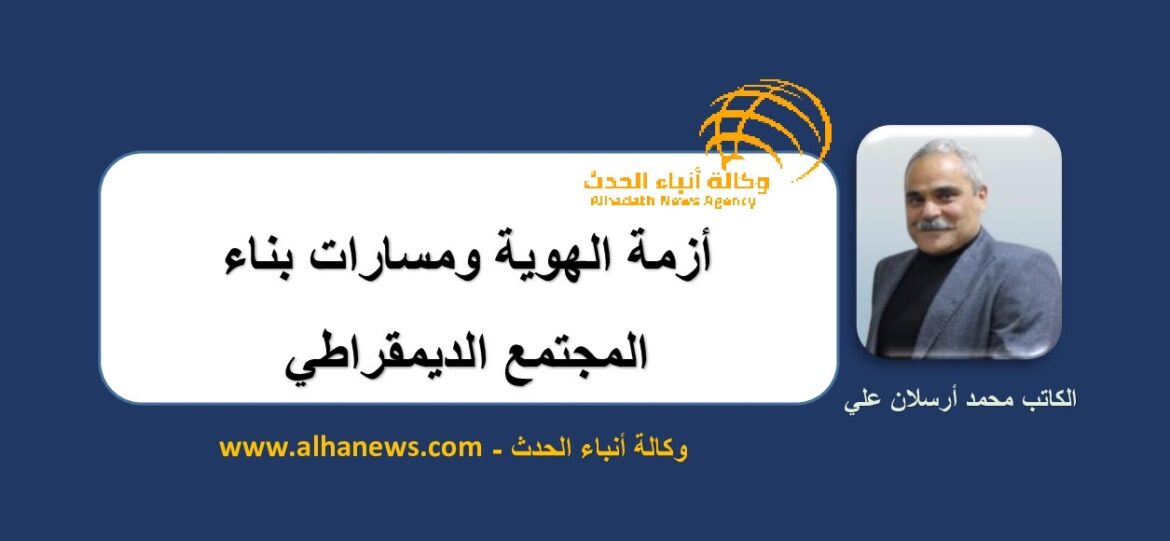
الحدث – بغداد
لطالما سعت الأنظمة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، منذ نشأتها الحديثة، إلى ترسيخ شرعيتها عبر بوابة التكامل مع القوى الخارجية، وغالباً ما جاء هذا المسعى على حساب التكامل الداخلي والمجتمعي. لقد أدى هذا التوجه إلى حالة من الاغتراب والقطيعة بين الدولة ومجتمعاتها، حيث تفككت الروابط الاجتماعية لصالح ولاءات ضيقة ومتباينة.
يتطلب فهم هذه الإشكالية استحضار عدد من المفاهيم المحورية التي ستكون حجر الزاوية في هذا المقال. أولاً، مفهوم “التكامل المجتمعي”، الذي يُعرَّف بأنه المشاركة الكاملة لجميع أفراد المجتمع في حياته العامة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. وهو مصطلح له جذور عميقة في مجالات متعددة مثل علم الاجتماع وعلم النفس المجتمعي. في المنطقة العربية، تبرز الحاجة إلى هذا النوع من التكامل كضرورة قصوى لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه شعوب الإقليم، عبر حوار مجتمعي يشارك فيه كافة المكونات القومية والإثنية والدينية.
ثانياً، مفهوم “الهوية الجامعة”، الذي يختلف عن الهويات الفرعية الضيقة القاتلة. تُعرف الهوية بأنها وعاء الضمير الجمعي الذي يحدد وعي الجماعة وإرادتها. بينما تُعرف “الهوية الوطنية” بأنها انتماء الفرد للوطن، وتعبير عن مشاركته الفعالة في صنع قراراته وحل مشكلاته، وعمله الجماعي مع الآخرين. وفي سياق هذا التحليل، سيتم استكشاف مفهوم “الهوية الجامعة” التي تسعى إلى توحيد الرؤى لبناء مجتمع ديمقراطي على أساس “أخوة الشعوب” والتعايش السلمي، بعيداً عن “الهويات القاتلة” التي أشار إليها بعض المفكرين.
ثالثاً، مفهوم “المواطنة”، الذي يتجاوز كونه مجرد علاقة قانونية بين الفرد والدولة. المواطنة هي شعور بالانتماء، يعبر عن هوية يكتسبها الفرد من خلال مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة. هي أيضاً علاقة بين الأفراد داخل الدولة، تقوم على مبادئ المساواة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون.
أما “الاندماج الديمقراطي”، فهو الهدف النهائي لهذا المسعى، حيث يتجسد في نظام سياسي يضمن التعددية الثقافية والسياسية ويتجاوز العرقية والطائفية الضيقة، مما يسمح للمواطنين بالعيش معاً وتحقيق الانسجام رغم الاختلاف.
وعلينا التأكيد إن الأزمة التي تعيشها دول المنطقة اليوم ليست وليدة اللحظة، بل هي محصلة لمسار تاريخي معقد، كان للمرحلة الاستعمارية دور محوري في تشكيله. فبعد انهيار الدولة العثمانية، قامت القوى الاستعمارية، ممثلة ببريطانيا وفرنسا، برسم حدود جديدة للمنطقة عبر اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916. لم تكن هذه الحدود نابعة من واقع مجتمعي أو ثقافي، بل كانت مصممة لخدمة المصالح الاستعمارية، مما أدى إلى فصل مجتمعات متجانسة وجمع مكونات متباينة داخل كيانات سياسية واحدة. وقد أدى هذا الواقع إلى نشوب نزاعات حدودية مستمرة بعد الاستقلال، مما يدل على هشاشة هذه الحدود وعدم تجذرها في الوعي الجمعي لشعوب المنطقة.
خلف هذا التقسيم، برزت ما يمكن تسميته بـ “الدولة القطرية المشوّهة أو أشباه الدول“. لقد افتقرت هذه الدول، منذ ولادتها، إلى الشرعية التاريخية والاجتماعية. فلم تكن نتاج إجماع شعبي أو حركة وطنية حقيقية، بل كانت “صناعة استعمارية”. وبدلاً من أن تسعى النخب الحاكمة لبناء “دولة حديثة” تستمد قوتها من مؤسساتها وعلاقتها بمجتمعها، انشغلت ببناء “دولة تحديثية”. هذه الدولة، وفقاً للتحليل، كانت شديدة المركزية، ذات طابع أمني قمعي، وحرمت المجتمع من بناء مؤسساته المدنية.
لم يقتصر الموروث الاستعماري على رسم الحدود فحسب، بل غرس نمطاً إدارياً واقتصادياً قائماً على السيطرة بدلاً من التنمية. فالموازنات التي وضعتها سلطات الانتداب، كما هو الحال في سوريا ولبنان، ركزت بشكل كبير على الإنفاق الأمني والعسكري على حساب القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والزراعة. هذا النمط الاقتصادي الأمني استمر بعد الاستقلال وأصبح سمة أساسية لـ “الدولة التحديثية” التي تولي الأولوية للسيطرة على حساب رفاهية المجتمع. هذا الواقع يفسر جزئياً التراجع الاقتصادي وتخلف هذه الدول عن مواكبة التطور العالمي.
ولعل أحد أبرز مظاهر فشل مشروع الدولة الوطنية في المنطقة هو عدم ارتقائها إلى مستوى “الوطن” واكتفائها بكونها “دولة قبائلية وطائفية”. وهنا نطرح إشكالية عميقة حول العلاقة بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية. إن الصراع ليس بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية بحد ذاتها، بل بين الدولة التي تفتقر للشرعية وتلك الهويات التي توفر وظائف اجتماعية حقيقية لأفرادها. لقد فشلت الدولة في تجاوز هذه الهويات لأنها لم تستطع تقديم بديل مجتمعي يمنح الأفراد الشعور بالانتماء والأمان الذي توفره الروابط القبلية والطائفية.
وقد استغلت النخب الحاكمة والمعارضة هذه الهويات الفرعية كأدوات سياسية لضمان السيطرة والحكم. هذا الاستخدام النفعي للهويات هو ما أدى إلى تحويلها من مجرد مكونات ثقافية إلى “هويات قاتلة”. هذه الهويات، أصبحت تتنازع فيما بينها ومع الهوية الوطنية، مما أضعف فكرة “المواطنة” التي تفترض المساواة والوحدة.
أدى هذا الفشل في بناء “دولة مجتمع” إلى أن يصبح الانتماء القبلي أو الطائفي يتقدم على الانتماء للوطن. هذه الظاهرة تفسر حالة الاغتراب والقطيعة، حيث شعر الفرد بأن الدولة لا تمثله ولا تعمل على حماية مصالحه، فبحث عن الأمن والانتماء في أطر اجتماعية أقدم وأكثر رسوخاً. هذا الواقع المعقد يبرز أن الهويات الفرعية ليست هي المشكلة في جوهرها، بل هي عرض لفشل الدولة في تحقيق مشروعها الوطني.
لقد تحولت الهويات الفرعية في الشرق الأوسط، في ظل انهيار الدولة المركزية، من مجرد مكونات ثقافية إلى قوى سياسية وعسكرية فاعلة، مما أدى إلى صراعات دموية وفوضى عارمة. تعد حالة العراق مثالاً بارزاً على هذا التحول. فبعد عام 2003، تحولت الطائفية من مجرد ظاهرة اجتماعية تاريخية إلى “ظاهرة سياسية” رسمية. لقد تم تكريس هذا الواقع من خلال نظام المحاصصة الطائفية، الذي أصبح بمثابة عرف سياسي دائم لتوزيع السلطة والنفوذ والثروة على أسس طائفية وعرقية. لم يكن هذا النظام حلاً، بل أداة لتثبيت الانقسام، مما أدى إلى صراعات دموية وتطهير طائفي وتغيير ديموغرافي في عدة مناطق.
وفي سوريا، بدأت الانتفاضة المدنية ضد الحكومة في عام 2011، لكنها تحولت تدريجياً إلى صراع طائفي وجودي. لقد انهارت المؤسسات الوطنية السورية وحلت محلها ولاءات محلية وخارجية، مما أدى إلى انقسام البلاد والمنطقة على أسس طائفية. وقد أسهمت الميليشيات الأجنبية، التي تتدفق للقتال في سوريا، في تعميق هذا الانقسام. هذه الميليشيات، التي قد يكون ولاؤها لقادة خارج سوريا، تزيد من وحشية القتال وتعيق أي تسوية سياسية.وهو ما نراه بوضوح الآن في ظل السلطة المؤقتة للجولاني. حيث الولاء لتركيا أعمى بصيرة السلطة المؤقتة وتحولت إلى أداة أو خنجر لضرب مكونات سوريا وذلك خدمة لأطماع إقليمية ودولية.
حيث ما حصل في الساحل السوري ومن بعده في السويداء من قتل وإرهاب وسبي وحرق، يعتبر جرائم حرب وليس له أية علاقة بالثورة وأهدافها. وبكل تأكيد لا يمكن نسيان ما حلَّ بالكنائس من تفجيرات وتهديد لهم، حيث كل ذلك يصب في خدمة تقسيم سوريا أكثر. وعيونهم متجهة نحو شرق وشمال سوريا مناطق نفوذ قسد، وهو ما ترمي له تركيا بذرع اقتتال وحرب أهلية في سوريا تستنزف فيها الكل. لكن قوات قسد بما تملكه من تجارب وإرادة وفكرسيسحق كل محاولة أو فكرة تحاول الاقتراب من مناطقها.
إن السبيل للخروج من حلقة الفوضى والاغتراب يكمن في بناء مشروع سياسي ومجتمعي جديد يرتكز على مفهوم “المواطنة الشاملة”. هذا المفهوم يتجاوز التعريف القانوني للمواطنة، ليصبح “شعوراً بالانتماء” وعلاقة بين الفرد ودولته والمجتمع ككل. ولربما ما يطرحه السيد عبد الله أوجلان من رؤية مستقبلية تحت عنوان (المجتمع الديمقراطي)، تكون بداية لحل قضايا ومشاكل المنطقة، وخارطة طريق يمكن الاعتماد عليها أو الاستفادة منها لحلحلة المشاكل وإخراج المجتمع من الفوضى التي بات يغرق فيها رويداً رويداً. التكامل الديمقراطي يعد مسيرة في مراجعة الذات والاعتماد على التعايش السلمي ما بين كافة شعوب المنطقة وفق أساس اخوة الشعوب التي لطالما اغتربنا عنها، جراء تقربات ومقاربات الأنظمة الاستبدادية وما أفرزته من عقليات أسوء منها، تجلت فيما تسمي نفسها “معارضة”. وهي أسوء ما انتجه النظام طيلة عقود خمسة.
لقد فشلت الدول القطرية لأنها ركزت على البعد المدني للمواطنة، وأهملت الأبعاد الأخرى، خاصة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. الحل يكمن في بناء دولة تضمن “الاندماج الكامل والفعّال” لأفرادها في المجتمع، بعيداً عن أنظمة المحاصصة الطائفية التي تفضل الولاءات الضيقة على حقوق المواطنة.
إن بناء “الهوية الجامعة” هو مشروع يتجاوز الحلول السياسية البحتة، فهو مشروع ثقافي وتنموي يهدف إلى خلق وعاء للضمير الجمعي يتجاوز “الهويات القاتلة” الضيقة. يمكن تحقيق هذا المشروع من خلال دمج قيم التسامح والتعايش السلمي في المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية والرياضية.
مآل القول: هو أن أزمة الشرق الأوسط هي في جوهرها أزمة شرعية وهوية، ناتجة عن فشل مشروع الدولة الوطنية في توفير بديل للهويات الفرعية، مما أدى إلى حالة من الاغتراب والفوضى. الحل لا يكمن في استمرار نماذج الماضي، بل في مشروع فكري وعملي جديد يعيد بناء العلاقة بين الفرد والدولة والمجتمع. يتطلب هذا المشروع التزاماً ببناء “المواطنة الشاملة” والابتعاد عن أنظمة المحاصصة، والعمل على بناء السلام من خلال جهود مجتمعية تنطلق من القاعدة، بالإضافة إلى تبني مشروع ثقافي وتنموي لبناء “هوية جامعة” تحتضن التنوع.
والنقطة الهامة الأخيرة هو الدور العربي المأمول من الفوضى التي تضرب المنطقة. فبكل تأكيد أن شعوب المنطقة بشكل عام ما عدا الذين قبلوا على نفسهم الخنوع، لا يقبلون بأن تحل تركيا وتعيث فساداً وارهاباً في المنطقة على حساب غياب الدور العربي. فدور السعودية ومصر لا يمكن التقليل من شأنه، وعليهما الخروج من شرنقة التقوقع وسياسة “وأنا مالي، يغورو بستين دهية”، والانتقال لمرحلة نفض غبار اللامبالاة وقطع الطريق على كل من له أطماع في المنطقة. بكل تأكيد تكاتف شعوب المنطقة مع بعضها البعض سيشكل قوة لا يمكن الاستهانة بها وسيعملون على بناء المجتمع والسلام على أساس التكامل الديمقراطي.
 +00000000
+00000000