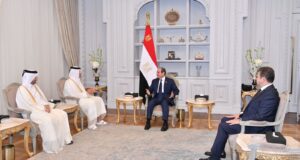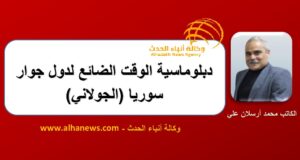هل كان السلام هزيمة؟ أم أن الحرب تأخرت كثيرًا عن نهايتها؟

الحدث – وكالات
في عام 2009، عندما كتب القائد عبد الله أوجلان مشروعًا تفصيليًا للسلام. تم نشره لاحقًا ككتاب بعنوان “حلّ السلام”، تضمّن رؤية جديدة تقوم على تجاوز الدولة القومية وبناء أمة ديمقراطية قاعدية لا مركزية. هذا المشروع لم يكن وثيقة تفاوض، بل بداية لرؤية فلسفية طويلة النفس.
وفي عام 2015، أُعلن عن “مفاوضات دولمة بهجة” بين الدولة التركية والحركة الكوردية، تضمّن الإعلان عشرة مبادئ، كان أبرزها الاعتراف المتبادل، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع.
ثم، في عام 2020، قدّم حزب العمال الكوردستاني في مؤتمره الاستثنائي مشروع سلام جديد. أعلن فيه أن زمن الحرب المفتوحة انتهى، وأن السلاح لن يُستخدم إلا للدفاع الذاتي، ضمن إطار أخلاقي وسياسي.
هذه الوثائق الثلاث ليست مجرد محطات سياسية، بل تعبير عن قراءة فلسفية عميقة لفهم النصر والهزيمة، وتجاوز الازدواجيات القاتلة في التفكير السياسي التقليدي.
إذا تعمقنا في فكر وفلسفة أوجلان خصوصا عبر مرافعاتها الأخيرة، نكتشف أن واحدة من أهم ركائز نقده للحضارة الغربية هي ما يسميه بـ”ميكانيزم ديكارت”. يرى أوجلان أن هذا النمط الفكري الذي أسس له رينيه ديكارت، والقائم على الثنائية القطعية (عقل–مادة، فاعل–مفعول، إنسان–طبيعة، ذات–موضوع، عدو-صديق، خائن-وطني..الخ)، هو الجذر المعرفي للعقلانية السلطوية، التي فصلت السياسة عن الأخلاق، والمجتمع عن الدولة، والفرد عن الجماعة.
وفق هذا المنطق الميكانيكي، تصبح الدولة آلة، والمجتمع مادة تُدار، والسياسة تقنية للهيمنة، والحرب امتدادًا طبيعيًا لهذا العقل الذي لا يرى الآخر إلا كخطر أو عدو.
أوجلان يدعو إلى كسر هذه الثنائية. لا من خلال نفي الدولة أو إلغاء القوة، بل من خلال إعادة تعريفهما ضمن عقلية تشاركية، حيث لا تُمارس السياسة من فوق، بل تُبنى من القاعدة، وتكون القوة تعبيرًا عن وعي مجتمعي، لا عن مركز فوقي متعجرف.
المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكوردستاني، الذي عقدت في الفترة من 5 إلى 7 أيار 2025، كان ذروة هذا التحول. جاء بمشاركة القائد أوجلان تقنياً، وتوّج مسارًا طويلًا من المراجعة الجذرية .يُرجح انه لم يكن المؤتمر مراجعة تنظيمية فقط، بل إعلانًا ضمنيًا عن “اللاعودة إلى الحرب”. ربما انتقل فيه النقاش من “كيف نقاتل؟” إلى “لماذا نستمر؟” ثم إلى “كيف نبني؟”.
التجارب العالمية تؤكد أن السلام لا يُبنى من أعلى. بعد الحرب العالمية الأولى، فُرضت اتفاقية فرساي على ألمانيا المهزومة، فكانت سببًا في الحرب الثانية. لكن بعد 1945، أُسست أوروبا على شراكة متوازنة، لا على إذلال. كذلك، في كولومبيا، أنهت حركة “فارك” نصف قرن من الحرب باتفاق سياسي في 2016، نال فيه مقاتلوها العفو، وشاركوا في البرلمان.
حزب العمال الكوردستاني لا يسعى إلى اتفاق هش، بل إلى تجسيد عملي للبراديغما الجديدة التي بلورها القائد أوجلان، منذ “الدفاع عن الشعب” وحتى المرافعات الخمسة. تلك المرافعات ليست وثائق نظرية، بل ثورة عقلانية على أنقاض التفكير السلطوي. في جوهرها، لا تقوم على توازن القوة العسكرية، بل على توازن الحياة الاجتماعية والثقافية. إنها دعوة لإعادة هندسة العلاقة بين الدولة والمجتمع، لا من خلال إعادة تدوير الهياكل القديمة، بل عبر تفكيكها وبناء أسس جديدة تنبثق من الأخلاق، والحرية، والمجتمع الحي.
لهذا، فإن المرحلة التي نعيشها اليوم ليست مرحلة إنهاء “حزب”، بل بداية تحوّل في الفهم. من التنظيم بوصفه غاية، إلى المجتمع بوصفه ذاتًا سياسية. من الحرب كأداة نهوض، إلى السلام كشرط وجود.
رغم كل التحديات، تظل هذه اللحظة لحظة أمل. ليس لأن الظروف مهيئة بالكامل، بل لأن البدائل الأخرى وصلت إلى نهاياتها. ما تبقى هو أن تصنع الشعوب سلامها بنفسها، بوعيها، بذاكرتها، وبدماء من سقطوا من أجل كرامتها.
السلام الحقيقي لا يُوقّع… بل يُبنى.
هل نملك الشجاعة لنخوض هذا الطريق؟ أم سنظل أسرى المعادلة القديمة؟
الزمن وحده لن يجيب. الشعوب هي التي تجيب.
 +00000000
+00000000